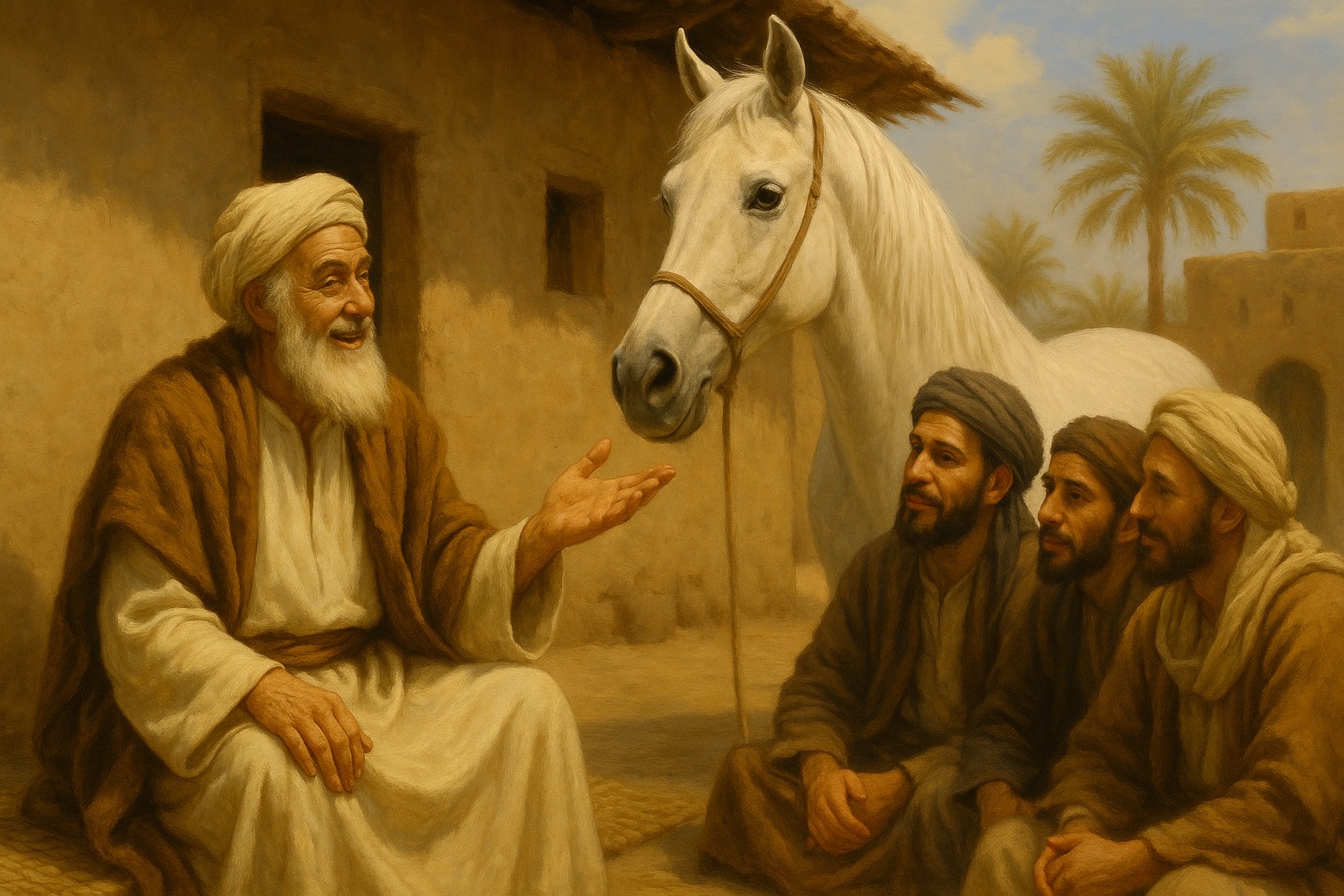
لم تكن الخيل مجرد وسيلة نقل أو أداة حرب في تاريخ العرب، بل تجاوزت مكانتها ذلك لتصبح جزءًا لا يتجزأ من هويتهم وثقافتهم. لقد عُرفت الخيل بـ”العز” و”الجمال” و”المنعة”، وكان العربي، حتى في أوقات الجدوبة والشدة، يفضلها على نفسه وأهله وولده، فيسقيها اللبن الخالص ويشربون هم الماء القراح. وقد كانت عناية العرب بالخيل شديدة، واهتمامهم بتربيتها بالغًا، لما وجدوا فيها من الشرف والمنافع، والقوة على عدوهم، والجمال في السفر والحضر.
إن هذه المكانة المتجذرة في الثقافة العربية الجاهلية لم تُلغَ بقدوم الإسلام، بل خضعت لعملية “إعادة تأطير” وتوجيه. فبينما كانت الخيل في الجاهلية قد ترتبط أحيانًا بمعتقدات وثنية، مثل تقديس أصنام على هيئة حصان كـ”يعوق” و”يعبوب” ، جاء الإسلام ليربط قيمتها مباشرة بالله تعالى والجهاد في سبيله. هذا التحول لم يكن سطحيًا، بل كان نابعًا من إرساء الإسلام لقاعدة التوحيد التي تستبعد أي تقديس لغير الله، وإدراك الشريعة لأهمية الخيل في نشر الدعوة والدفاع عن الأمة. وهكذا، تحولت العاطفة العميقة للعرب نحو الخيل لتكون في خدمة الدين، وهو ما يفسر الأحاديث الكثيرة التي منحت الخيل فضائل عظيمة وجعلتها أداة للقوة والعزة في الإسلام.
أقسم الله عز وجل بالخيل في كتابه الكريم، وهذا القسم الإلهي يؤكد على عظيم شأنها ومكانتها. ورد هذا القسم في مطلع سورة العاديات، حيث يقول الله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا}. تحمل هذه الآيات دلالات عميقة حول الخيل ودورها:
“وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا”: تشير إلى الخيل التي تجري وتعدو بسرعة، ويُسمع صوت ضبحها، وهو صوت أنفاسها اللاهثة عند الجري الشديد. هذا القسم يدل على قوتها وسرعتها.
“فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا”: تصف الخيل التي تقدح النار بحوافرها عند اصطدامها بالصخور أثناء العدو، خاصة في الليل، وهذا يرمز إلى شدة جريها وقوتها.
“فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا”: تصف الخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح الباكر، وهو الوقت المعتاد لشن الغارات الحربية، مما يدل على دورها الحاسم في الهجوم والمباغتة.
“فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا”: تشير إلى إثارة الخيل للغبار الكثيف بسبب كثرة جريها في ساحة المعركة، مما يدل على شدة القتال.
“فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا”: تصف الخيل التي تقتحم صفوف الأعداء وتتوسط جموعهم، وهذا يرمز إلى شجاعتها وقدرتها على تحقيق النصر.
وقد اختلف المفسرون في المراد بـ”العاديات”، هل هي الخيل أم الإبل؟ لكن جمهور المفسرين رجحوا أنها الخيل، لأن ألفاظ مثل “القدح” و”الصبح” تناسب الخيل أكثر من الإبل، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا لضرورة.
كما ورد ذكر الخيل في آيات أخرى، منها قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}، حيث أرشدت الآية إلى اتخاذ الخيل لإعداد القوة للجهاد. وتوضح قصة النبي سليمان عليه السلام مع “الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ” (الخيل الواقفة على ثلاث قوائم وطرف الرابعة) أن اهتمامه بها كان لغاية دينية جهادية، وليس لمجرد اللهو، وهو ما يفسر سبب “مسحه” على سوقها وأعناقها.
شكلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالخيل إطارًا شرعيًا متكاملًا يرفع من قدرها ويحدد ضوابط التعامل معها.
حديث “الخير معقود في نواصي الخيل”: يعتبر هذا الحديث من أشهر الأحاديث في فضل الخيل، وقد ورد بألفاظ متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: “الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة”. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير بأنه الأجر والثواب في الآخرة، والغنيمة والرزق في الدنيا. كما أن “النواصي” (شعر مقدمة الرأس) لا تُقْص، لأن الخير معقود فيها، وهو ما يثبت مكانتها وبركتها.
تصنيف الخيل إلى ثلاثة أقسام: قدم النبي صلى الله عليه وسلم تصنيفًا بليغًا للخيل، يوضح فيه قيمتها بحسب نية صاحبها: “الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر”. وقد فُصّل هذا التصنيف كالآتي:
فرس الأجر: ما اتخذه الرجل للجهاد في سبيل الله إيمانًا به وتصديقًا بوعده، فكل ما ينفق عليه من طعام وشراب وروث وبول، يكون أجرًا وثوابًا في ميزان صاحبه يوم القيامة.
فرس الستر: ما اتخذه الرجل للاكتفاء والتعفف عن سؤال الناس، فلا ينسى حق الله في ظهره ورقبته، فهذا يكون سترًا له من الفقر والحاجة.
فرس الوزر: ما اتخذه الرجل فخرًا ورياءً ومناوأةً لأهل الإسلام، فهذا يكون وزرًا وخسرانًا عليه يوم القيامة.
هذا التصنيف النبوي يوضح أن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الشيء بذاته، بل إلى المقصد والغاية من استخدامه. فالخيل هي نفسها، لكن قيمتها الشرعية تختلف تمامًا بحسب نية وعمل صاحبها، مما يؤكد على أن القيمة الحقيقية للأشياء في الإسلام تنبع من ارتباطها بالمقاصد الإيمانية والأخلاقية.
اهتم المسلمون الأوائل بتسمية خيولهم، وحفظ قصصها، مما يعكس عمق العلاقة العاطفية بين الفارس وفرسه. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الخيل المعروفة، وكذلك لبعض الصحابة.
|
اسم الفرس |
صاحبه |
أبرز صفاته وقصصه |
|
السكب |
النبي صلى الله عليه وسلم |
كان أول فرس يملكه في المدينة، اشتراه بعشر أواق من الفضة. شارك في غزوة أحد. |
|
البحر |
النبي صلى الله عليه وسلم |
سابق به النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في المرتبة الأولى، فجثا على ركبتيه ومسح وجهه وقال: “إنه لبحر”. |
|
المرتجز |
النبي صلى الله عليه وسلم |
سُمِّي بذلك لحسن صهيله، وكان أبيض اللون. |
|
اللزاز |
النبي صلى الله عليه وسلم |
أهداه له المقوقس ملك مصر. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه في غزواته. |
|
سبحة |
النبي صلى الله عليه وسلم |
مهرة اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعشرة من الإبل، وسابق بها فجاءت سابقة، فسر بذلك. |
|
الحضار |
حذيفة بن بدر |
سابق به حتى أدركه فرس يسمى اللّاحق. |
|
القعساء |
زهير بن جذيمة العبسي |
فرس مشهورة كانت له. |
|
الحمالة |
التطفيل بن مالك |
فرس مشهورة كانت له. |
|
العرادة |
أبي داود الإيادي |
فرس مشهورة كانت له. |
|
الصموت |
العباس بن مرداس |
فرس مشهورة كانت له. |
|
الأدهم |
عمر بن الخطاب |
فرس مشهورة كانت له. |
إن هذه القصص والأسماء التي حفظها لنا التاريخ لا تقتصر على كونها معلومات تاريخية، بل تبرز عمق العلاقة التي كانت تربط المسلمين بخيولهم. فالاهتمام بتسمية الخيل، وتدوين قصصها، وتفصيل أحوالها، يوضح أنها لم تكن مجرد أدوات، بل كانت أفرادًا تحظى بالتقدير، مما يرسخ في الوعي الإسلامي ضرورة تكريمها ورعايتها.
تتجلى مكانة الخيل في الإسلام في ربطها المحكم بالجهاد، فهي رمز القوة والعزة. وقد ورد الأمر بإعدادها للجهاد في قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}. وقد فُسرت “القوة” في الآية بالرمي، أما “رباط الخيل” فيشمل إعدادها وتجهيزها للمعركة.
ولعظيم دورها في القتال، خصصت الشريعة لها سهمًا من الغنيمة. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة يوم خيبر ويوم بني قريظة، فجعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا واحدًا، ليصبح نصيب الفارس ثلاثة أسهم. هذا التفضيل المادي للخيل يبرز مدى أهميتها الاستراتيجية في تحقيق النصر.
شجّع الإسلام على ممارسة الفروسية، ومن صور ذلك المسابقة بالخيل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. إلا أن هذه المسابقات كانت محكومة بضوابط شرعية دقيقة، ففرق الفقهاء بين “السبق” الجائز و”القمار” المحرم.
السبق الجائز: هو ما كان جائزة من طرف واحد، كأن يقول أحدهم: إن سبقتني فلك كذا، أو من طرف ثالث (محلل) يدخل المسابقة بفرسه دون أن يدفع شيئًا، فإذا سبق أخذ الجائزة، وإن لم يسبق لم يغب منه شيء. وهذا النوع من السبق يهدف إلى تشجيع المسلمين على التدرب على الفروسية والرماية، كونها من أدوات القوة، دون تحويلها إلى وسيلة للكسب المحض.
القمار المحرم: هو ما كان فيه عوض من كلا الطرفين، كأن يقول كل منهما: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلي كذا.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن “الجلب” (الصياح خلف الخيل لتحريضها) و”الجنب” (الاستعانة بفرس آخر) في المسابقة. هذا النهي يوضح أن الإسلام لا يشجع على الفوز بأي وسيلة، بل على ممارسة المنافسة الشريفة والأخلاقية، بعيدًا عن الغش والخداع.
ورد في السنة النبوية أن الخيل لا تجب فيها الزكاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق”. وفسر الفقهاء هذا الحديث بأن هذا الحكم يسري على الخيل التي اتخذت للجهاد في سبيل الله أو للركوب. أما الخيل التي اتخذت للتجارة (المعروضة للبيع)، فتجب فيها الزكاة، وهو قول جمهور الفقهاء.
حثت الشريعة الإسلامية على الرفق بالخيل وتكريمها، ونهت عن كل ما يؤذيها أو يذلها.
الرفق والتكريم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الخيل، ونهى عن ضرب وجهها.
النهي عن الإخصاء: ورد النهي عن إخصاء الخيل، معللاً بأن في ذلك تغييرًا لخلق الله، وحاجةً إلى النسل. وقد أجاز بعض العلماء الإخصاء للمصلحة، مثل علاج سوء خلق الفرس أو عدوانيته.
النهي عن قطع النواصي والأذناب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع نواصي الخيل وأذنابها، موضحًا أسباب ذلك: “أذنابها مذابها ومعارفها دفؤها ونواصيها معقود فيها الخير”. فكل جزء من الفرس له وظيفته وحكمته. هذه التفاصيل الدقيقة تظهر عمق فهم الشريعة لطبيعة الخيل وخصائصها، وأنها لا تكتفي بالأحكام العامة، بل تقدم إرشادات عملية تضمن رعاية مثلى للحيوان.
اهتم العرب بصفات الخيل وألوانها، وقد جاءت الشريعة لتؤصل هذا الاهتمام وتوجهه.
الألوان المفضلة:
الشقراء: فُضّلت الخيل الشقر (الحمراء) في أحاديث نبوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يُمْنُ الخَيْلِ فِي شُقْرِها”. ويرجع هذا التفضيل إلى موقف محدد، حيث إن أول فرس جاء بالفتح في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كان فرسًا أشقر.
الأدهم الأغر المحجل: فُضّل الأدهم (الأسود) الذي في جبهته بياض (أغر) وفي قوائمه بياض (محجل)، لكونه يجمع بين القوة والجمال.
الشيات (العلامات) المحمودة والمذمومة:
التحجيل والغرة: من الشيات المستحبة البياض في قوائم الخيل (التحجيل) وبياض جبهتها (الغرة).
الشكال: كُره الشكال، وهو أن يكون في رجل الفرس بياض وفي يده المخالفة بياض. وقد علل العلماء كراهته بأنه يشبه الفرس المربوط، وهذا قد يثير التشاؤم.
إن هذا الربط بين الصفات الجسدية للخيل والأحكام الشرعية لا يعود إلى خرافات، بل إلى فقه عميق يربط الأحكام بالواقع والدلالات النفسية. فالشريعة تأخذ في الاعتبار كيف يمكن لصفة ما أن تؤثر في نفسية الإنسان، سواء بالإيجاب (تفضيل الشقر لما ارتبط بها من نصر) أو بالسلب (كراهة الشكال لما قد يثيره من تشاؤم).
واجهت الشريعة الإسلامية المعتقدات الجاهلية، وقامت بتصحيحها وتهذيبها.
حديث “الشؤم في ثلاثة”:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار”.
هذا الحديث قد يُفهم منه التشاؤم المنهي عنه في الإسلام، لكن العلماء قدموا تفسيرات عدة لتوضيح دلالته الصحيحة، منها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي قول اليهود، وأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يسمع بداية الحديث، وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها.
أن الشؤم هنا لا يعني الخرافة، بل المشقة والضرر المحسوس، كأن تكون المرأة غير ولود، أو البيت ضيقًا، أو الفرس صعب المراس.
أن الحديث استثناء من قاعدة نفي الطيرة، أي أن الشؤم لو كان موجودًا لحُصر في هذه الثلاثة، ولكنه غير موجود على وجه الإطلاق، وهو ما يتوافق مع عموم النصوص التي تنهى عن الطيرة والتشاؤم.
أساطير الخيل المجنحة والجن:
لم تقتصر الأساطير الجاهلية على الأصنام، بل امتدت لتشمل الخيل المجنحة، وقد ورد في بعض الروايات أن خيول النبي سليمان عليه السلام كان لها أجنحة، وأن أول من ركب الخيل المجنحة هو إسماعيل عليه السلام، وأن بعضها طار وعاد إلى البحر.
وقد أصل الإسلام لهذه الأساطير، فأورد قصة ألعاب السيدة عائشة رضي الله عنها، التي كان لديها فرس بلعبتين وله جناحان، وحين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فرس وله أجنحة؟”، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.
كما أن الإسلام أثبت وجود مركب خاص بالأنبياء وهو “البراق”، الذي هو أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى بصره. وهذا يوضح أن الإسلام لم يلغِ فكرة الخيل ذات الصفات الخارقة تمامًا، بل وجهها إلى إطارها الصحيح المرتبط بالأنبياء والمعجزات.
تُظهر هذه الدراسة أن مكانة الخيل في الشريعة الإسلامية ليست مجرد مكانة عابرة، بل هي منظومة متكاملة من الأحكام والآداب التي تعكس نظرة الشريعة الشاملة. فقد ارتبطت الخيل بالجهاد والأجر والثواب، وحُددت ضوابط استخدامها في المسابقات والرهان، وعُفيت عن الزكاة في كثير من أحوالها، وقُدمت أحكام مفصلة لرعايتها.
إن هذا التراث الغني يمثل إرثًا ثقافيًا وفقهيًا عظيمًا. لذلك، يوصى بما يلي:
إحياء الاهتمام بالخيل: تشجيع إحياء الاهتمام بالخيل وتربيتها، لا سيما في العالم العربي، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث والهوية.
الرعاية الأخلاقية: التأكيد على أهمية الرفق بالحيوان وتجنب الإهانات والممارسات الخاطئة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل معها.
التعليم والتوعية: ضرورة تقديم برامج توعية تثقيفية للجمهور حول مكانة الخيل في الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ودحض الخرافات التي قد تكون عالقة في الأذهان.